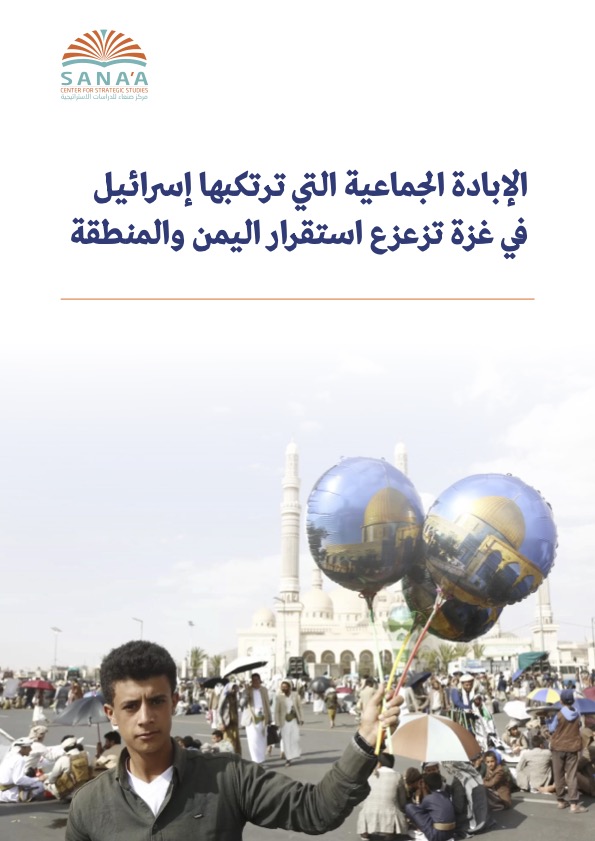شهد الشرق الأوسط تصعيداً في أعمال العنف وزيادة في التقلبات منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد فتح هجوم حماس على إسرائيل الباب أمام إسرائيل لتحقيق طموحاتها في إعادة تشكيل المنطقة، وبالتالي تأجيج نيران عدم الاستقرار في عدد من الدول، وفي غزة لم تكن هذه الطموحات مدفوعة باللامبالاة الغربية فحسب، بل بالتحريض الغربي المباشر، وفي اليمن، تجلى عدم الاستقرار في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وضد إسرائيل، مما دفع بعض القوى العسكرية العظمى في العالم إلى اتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة.
أسفرت حروب إسرائيل – من غزة والضفة الغربية إلى اليمن ولبنان وسوريا وإيران – عن مقتل عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الأشخاص وتدمير مادي هائل، مما زرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل. على وجه الخصوص، يهدد التدمير المستمر لغزة بتوجيه ضربة قاضية للنظام الدولي القائم على القواعد الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، وستعاني المنطقة والعالم من العواقب الوخيمة لذلك لعقود قادمة.
قبل دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين حيز التنفيذ في 6 مايو، شنت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من ألف غارة جوية على اليمن في إطار عملية “الراكب الخشن”. الحملة الأمريكية التي أطلقت لمواجهة الحوثيين واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر واستمرت لثمانية أسابيع، تسببت القنابل الأمريكية خلالها بسقوط أكثر من 700 ضحية مدنية حسب التقارير، حيث أسفر قصف منشأة لتخزين الوقود في ميناء رأس عيسى بالحديدة في 18 أبريل، عن مقتل أكثر من 80 مدنياً (في ما وصفته هيومن رايتس ووتش بــ”جريمة حرب واضحة“)، كما أسفر قصف مركز لاحتجاز المهاجرين بصعدة في 28 أبريل، عن مقتل ما لا يقل عن 60 مهاجر أفريقي.
واصل الحوثيون هجماتهم ضد إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية في إزهاق الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية في اليمن، حيث قصفت البحرية الإسرائيلية ميناء الحديدة في 10 يونيو، وأفادت تقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف رئيس أركان الحوثيين محمد الغماري، في 14 يونيو، وشنت حوالي 20 طائرة مقاتلة إسرائيلية أكثر من 50 غارة على الحديدة والموانئ المحيطة بها في 6 يوليو، ولم تكن هناك تقارير عن حجم الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء العمليات الإسرائيلية.
كانت القنابل التي ألقيت على اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، إلا إن الطريقة التي استفز بها الحوثيون هذا العمل العسكري كانت متعمدة وواضحة. ربما لم يتوقع الحوثيون شدة تلك الهجمات، لكنهم توقعوا بكل تأكيد رداً عسكرياً عندما أعلنوا استئناف هجماتهم على السفن في مارس، بعد قرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة، ومرة أخرى بعد وقف إطلاق النار الأمريكي مباشرة، عندما أعلن الحوثيون أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل وأن هجماتهم ستستمر دعماً لغزة. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة وبدعم من حلفاء آخرين، قد أمضى العام الأخير من ولايته في محاولة قصف الحوثيين لإجبارهم على الاستسلام من خلال عملية بوسيدون آرتشر. اختار الحوثيون التصعيد على الرغم من المخاطر المتوقعة على صفوفهم وعلى المدنيين، وبذلك يتحمل الحوثيون جزءاً من المسؤولية عن المعاناة المتفاقمة للسكان الواقعين تحت سلطتهم.
من المهم معرفة الدور الحوثي في التسبب بهذه الغارات الجوية والدمار الذي أحدثته، وقد أورد مركز صنعاء تقارير مستفيضة عن الطرق العديدة التي استغل بها الحوثيون غزة لتحقيق مكاسب سياسية، حيث قمع الحوثيون المجتمع المدني، وكثفوا تجنيدهم للمجندين الأطفال، وزادوا من مستويات القمع، وعززوا موقفهم داخلياً من خلال تدابير استبدادية متزايدة، وعلى الرغم من ذلك لا تكتمل أي تحليلات دون إيلاء الاهتمام اللازم بالكيفية التي ساهم بها العدوان الإسرائيلي بدعم غربي في زعزعة استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه خلق مساحة سياسية وأخلاقية لاتخاذ إجراءات مثل تلك التي نفذها الحوثيون.
نهاية القانون الدولي
منذ 7 أكتوبر 2023، استخدمت إسرائيل القصف العشوائي والجوع كسلاح وقتلت أكثر من 57,000 فلسطيني، وقد يصل عددهم إلى 86,000 وفقاً لمسح الوفيات الأخير في غزة، وحُولت مواقع توزيع المواد الغذائية التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى “حقول قتل” وفقاً لتقرير كشفته صحيفة هآرتس مؤخراً، وكما أفادت لويز واتريدج كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الأونروا قبل ستة أشهر، فإن غزة تسجل أعلى معدل للأطفال مبتوري الأطراف بالنسبة لعدد السكان. تواجه إسرائيل الآن اتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية، وهي أخطر الجرائم الدولية وأشد التهم التي يمكن توجيهها لدولة، ومع تزايد إجماع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والخبراء القانونيين وعلماء الإبادة الجماعية على أن الوضع في غزة يستدعي مثل هذا الوصف، فإن المبرر الأخلاقي للتدخل يستدعي ذلك أيضاً.
أدى كل من الفشل في منع الفظائع الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة ورواندا في التسعينيات، وما تلاه من تدخل حلف شمال الأطلسي غير المصرح به (على الرغم من أن الدول الأعضاء في الحلف اعتبرته مبرراً) في كوسوفو عام 1999، لوقف التطهير العرقي الذي قام به الصرب ضد السكان الألبان المحليين، إلى دخول عصر التفاؤل التدخلي، حيث صاغت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول عام 2001، مبدأ “مسؤولية الحماية” واعتمده مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005، بالإجماع، لكن الخبراء أعلنوا لاحقاً موت هذه القاعدة بعد التدخل الذي قاده حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011، ومرة أخرى بعد فشل المجتمع الدولي في الرد على عمليات القتل الجماعي في سوريا.
بغض النظر عن المناقشات المهمة حول عالمية مبدأ مسؤولية الحماية، فإن ما يفعله الحوثيون الآن لا يختلف كثيراً أخلاقياً أو منهجياً عن التدخل الذي دافعت عنه الدول الغربية طوال معظم القرن الحادي والعشرين، وهذا لا يشكل فضلاً للحوثيين، بل يشير إلى فشل ذريع للديمقراطيات الليبرالية الغربية في فرض “نظامها القائم على القواعد” واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
استند رد الدول الغربية على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى التمسك بالقانون الدولي وحماية المدنيين، الحماية التي حُرم منها المدنيون في فلسطين وإيران ولبنان وسوريا واليمن. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومحرقة الهولوكوست، أنشأت الدول الغربية أدوات قانونية وسياسية لمنع تكرارها، وقد أدت محرقة الهولوكوست نفسها إلى ظهور مصطلح “الإبادة الجماعية” كفئة قانونية قائمة بذاتها، وبما أن صانعي هذه الأدوات أنفسهم قد تخلوا عنها، فقد أصبح القانون الدولي والنظام الدولي الليبرالي نفسه ضحية أخرى للإبادة الجماعية للفلسطينيين.
كانت المكاسب السياسية التي حققها الحوثيون من معارضة الإجراءات الإسرائيلية أيضاً انعكاساً للمواقف المترددة للدول المجاورة، حيث حافظت النخب السياسية والاقتصادية في مصر والأردن والإمارات والبحرين والجزائر والمغرب وتركيا على علاقاتها مع إسرائيل، وسهّلت السعودية ومصر والأردن التجارة الإسرائيلية عبر موانئ الإمارات والبحرين طوال أزمة البحر الأحمر، وسمح هذا الانفصال بين القيادة السياسية في المنطقة والدعم الشعبي الساحق لتحرير فلسطين للمشاعر المؤيدة للحوثيين بالتنامي الكبير. تخلت دول المنطقة عن موقفها المبدئي المؤيد لفلسطين نتيجة لتشابكها العميق مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية، ما أدى إلى تقييد كبير لقدرتها على الرد باتساق على أعمال الحوثيين، حتى في الوقت الذي تتكبد فيه اقتصادات موانئ المنطقة خسائر فادحة.
حروب إسرائيل في الشرق الأوسط
بعيداً عن خلقها المجال السياسي والأخلاقي للردود العسكرية، فإن سياسة إسرائيل الخارجية العدوانية، تعكس سياسة الإرهاب التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل بشكل مباشر وغير مباشر على زعزعة استقرار المنطقة، حيث أدى غزوها وقصفها للبنان إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، من أصل اجمالي السكان البالغ تقديراً 5.5 مليون نسمة. بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر 2024، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 3,000 انتهاك نتج عنها أكثر من 200 قتيل، وفقاً للسلطات اللبنانية، وتواصل إسرائيل احتلال خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان متحدية لبنود وقف إطلاق النار، وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على بيروت بين أواخر مارس وأوائل أبريل، ومرة أخرى في يونيو، عشية عيد الأضحى، مستهدفًا مواقع تصنيع طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله، وفي 9 يوليو، أعلنت إسرائيل عن شن غارات برية جديدة على لبنان، استهدفت حسب التقارير، البنية التحتية وأفراد حزب الله.
في سوريا المجاورة، شنت إسرائيل عمليات عسكرية وقائية واسعة النطاق للاستيلاء على أراضٍ سورية وتدمير قدرات البلاد العسكرية، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، ما يزال الجيش الإسرائيلي يحتل مواقع في جنوب سوريا، وينوي البقاء فيها “في المستقبل القريب“، وتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية استهداف القواعد العسكرية والمدن السورية كدمشق ومدينة اللاذقية الساحلية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا. لقد أدان جير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الغارات الجوية ودعا إسرائيل إلى “التوقف عن تعريض المدنيين السوريين للخطر واحترام القانون الدولي وسيادة سوريا”.
تفسر الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ردود الفعل المتحفظة من الحكومات الحليفة على أنها تفويض مطلق لاتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية في المنطقة. شنت إسرائيل هجومها الذي انتظرته طويلاً على إيران في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو، واستهدفت الهجمات منشآت نووية، مثل محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وكبار العلماء النوويين والعسكريين، ومواقع مدنية، مثل محطة الإذاعة الحكومية الإيرانية، وردت إيران بالمثل، بإطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب. سرعان ما تعهد الحوثيون بتقديم دعمهم الكامل لإيران، على الرغم من أن ردهم العام كان ضئيلاً وفقاً للتقارير، كون إيران أرادت منع تدخل أمريكي أكبر. كانت تقييمات الاستخبارات الأمريكية التي تشير إلى أن طهران لا تزال بعيدة عن حيازة أسلحة نووية بسنوات، وأنها لا تسعى بنشاط إلى حيازة أسلحة نووية، قد نفت الأساس المنطقي للهجوم الإسرائيلي الزاعم أن إيران على وشك تطوير أسلحة نووية.
أفادت الكثير من التقارير بعدم امتلاك إسرائيل للقنابل الخارقة للتحصينات اللازمة لضرب منشأة التخصيب الإيرانية فوردو، الواقعة تحت الأرض ضربة فعالة، وكانت بالتالي بحاجة إلى المساعدة الأمريكية لإنجاز هذه المهمة، وقد استجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 يونيو، وشن غارات جوية على منشآت نووية إيرانية من ضمنها منشأة فوردو. رغم عدم نشر تقييم شامل ومستقل للأضرار التي أحدثتها الضربات، فقد وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها “جسيمة وفادحة”، لكنه لا يُرجح أن تكون المواقع قد “دمرت بالكامل” كما يُزعم، حيث أشار تقييم أولي للبنتاغون وهو تقرير استخف به ترامب، إلى أن الغارات الجوية فشلت في “تدمير المكونات الأساسية لبرنامج إيران النووي”، على الرغم من أن تقييمًا لاحقًا للبنتاغون قال إن الغارات ربما أعاقت برنامج إيران النووي وأخرته لمدة تصل إلى عامين، في حين أشار رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران قد تستأنف عملية التخصيب في غضون أشهر.
يبدو أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 24 يونيو، ما يزال ساريًا، لكن التوترات بدورها ما تزال مرتفعة، وقد أوضح ترامب أن قصف إيران مرة أخرى لا يزال خيارًا مطروحًا، ولم تتحقق بعد المفاوضات الجديدة حول برنامج إيران النووي، على الرغم من الضغوط الأمريكية في هذا الجانب.
كانت الآثار الضارة لمبدأ “الدفاع الاستباقي” الإيراني على استقرار المنطقة واضحة دوماً للمراقبين في اليمن، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن اعتبار حملة القصف المستمرة من قبل إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة ثاني أكبر قوة نووية في العالم، استراتيجية موثوقة لمنع انتشار الأسلحة النووية.
تحرير فلسطين شرط أساسي لاستقرار المنطقة
تبرر إسرائيل مساعيها لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بمفهومها الواسع للأمن، الذي يستخدم تعريفاً مرنًا للتهديدات وتفسيراً متطرفًا للتدابير المسموح بها للرد عليها، ولم تكن اليمن بمنأى عن الاضطرابات التي تبعت النزعة العسكرية الإسرائيلية.
تتسم الديناميات الداخلية في اليمن بالتشرذم السياسي والاختلال العسكري، وما يفاقمهما من تحديات بيئية وانهيار اقتصادي، وهما عاملان كافيان لتعقيد أي مساعٍ نحو السلام، لكن من الواضح أن هذه التحديات تتفاقم بسبب الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه إسرائيل على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث حولت أزمة البحر الأحمر النهج الدولي تجاه اليمن إلى نهج ينظر إلى اليمن من منظور أمني في المقام الأول، وبسبب المخاوف بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، همشت احتياجات اليمنيين الذين يحتاج 18 مليون منهم إلى مساعدات إنسانية ويُعد 4.5 مليون منهم من النازحين، أما الدول الغربية فيقوض فشلها في محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة من مصداقيتها كوسيط نزيه في اليمن، ويزيد من تفاقم المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.
من المحتم أن تؤدي مغامرات إسرائيل العسكرية إلى صدمات سياسية لا تزال نتائجها تتكشف، فغالباً ما يؤدي الصراع إلى دورات جديدة من العنف، ويدفع إلى النزوح والهشاشة الاقتصادية، ويشجع نمو وظهور جماعات ما دون الدولة . أدى غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بعد عقد من الزمن، وبالمثل تضع عدوانية إسرائيل اليوم بالتأكيد حجر الأساس لصراعات مستقبلية قد لا يُفهم مداها الكامل إلا بعد سنوات من الآن.
على الرغم أنه من الملائم سياسياً تقسيم الأزمات العديدة في المنطقة إلى فئات منفصلة، إلا أن اليمن يبرز بقوة مدى الترابط في الجغرافيا السياسية. في الوقت الذي تعاني فيه شعوب المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية معقدة، لا يمكن أن يعزى معظمها إلى سبب واحد ولا يوجد حل سهل لها، يظل تحقيق العدالة للفلسطينيين بناء على المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، الشرط الأساسي لتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط.
يأتي هذا المقال ضمن سلسلة من الإصدارات التي يُنتجها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بتمويل من حكومة مملكة هولندا. تغطي السلسلة موضوعات اقتصادية وسياسية وبيئية، تهدف إلى تغذية النقاش العام وصنع السياسات المتعلقة باليمن بما يعزّز تحقيق سلام مستدام. لا تُعبّر الآراء الواردة في هذه المادة بالضرورة عن مواقف مركز صنعاء أو حكومة هولندا.

 Read this in English
Read this in English